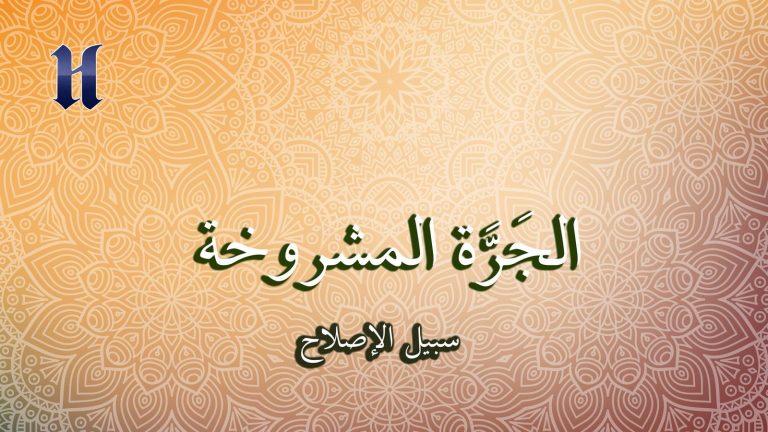إن حبَّ الدنيا لزينتها ومُتعها وشهواتها، هو إيثارٌ لها على الآخرة عن علمٍ وقصدٍ؛ وهذا من أعظم بلايا عصرنا.. إذ يُفتَنُ كثيرون اليوم بجمالياتها الآسرة، ويرتبط ضعاف الإيمان بها بكلّ كيانهم، ويحبونها لدرجة العبادة، ويفضّلونها على الآخرة، ويتشبّثون بها وكأنهم سيُخلّدون فيها أبدًا، ويُفنون أعمارهم خلف طول الأمل.
فإن أولئك الذين ترتبط قلوبهم ارتباطًا وثيقًا بالدنيا لا تخرج عبادتُهم عن كونها عبادةً شكليّةً وسطحيّة، إذ لا بد من ارتباط القلب بالله تعالى أثناء العبادة، وأن يتعلّق الإنسان بربِّه بكل كيانه، وأن يعبده بعشقٍ وخشوعٍ وخشيةٍ، مستغرقًا فيه دون انشغالٍ بما سواه تعالى، إلى أن تنساب أنّات قلبه على لسانه وشفتيه بِصِيَغِ الدعاء.. وما أجمل أن يوافق موضوعَنا هذا القولُ النفيس للشاعر “فضولي”:
ليس بعارفٍ مَنْ يعرف أمور الدنيا وما فيها
وإنما العارفُ هو مَنْ لا يَأبَهُ بالدنيا وما فيها
فمن يتوجه إلى الله تعالى بصدقٍ تنمحي أمام عينيه كلُّ مفاتن الدنيا تمامًا كما تنمحي النجوم من مرأى السماء حينما تشرق الشمس، بل يأتي عليه وقتٌ لا يكاد يرى حتى نفسه.
وكما يقول بديع الزمان سعيد النورسي: “إن هذا العصر قد جعل حتى المسلمين يستحبّون الحياة الدنيا ويرجّحونها على الآخرة على علمٍ منهم ورغبة”[1].. فللأسف لا هَمَّ لمن يصلّون في المسجد، أو يطوفون حول الكعبة، أو يتوسّلون ويتضرّعون إلى الله في عرفات إلا الدنيا، فلو أصغينا إلى دعواتهم لأدركنا أنها في الغالب لا تتجاوز المطالب الدنيوية.. وبصرف النظر عن سؤالهم الدنيا في دعائهم فإنهم يجعلون عبادتهم وعبوديتهم واسطة لطموحاتهم الدنيوية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: “رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ”[2].. إن الأساس في العبودية هو الإخلاص والصدق، وإن أيَّ إدخال للجاه والمستقبل، أو الأولاد والعيال، أو المقام والمنصب، أو الصيت والشهرة ضمن العبادة؛ قد يدنّسها ويشوّهها.. ومما يُؤسَفُ له أن عصرَنا هو عصر عبّاد الدنيا، ومن الصعب للغاية التخلّص من هذا الخطر.
يصوّر القرآن الكريم عصرنا بقوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ * وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ﴾ (سورة القِيامَةِ: 75/20-21)، فلو كان هناك مرضٌ أخطر من الوباء والطاعون والجذام والإيدز في عصرنا الحالي فهو ذلك المرض الذي يضع الدنيا في المقام الأول على نحو يلوّث العبودية ويدنّسها، وإذا ما تسلّط هذا المرض على أحدٍ لقضى عليه وأهلكه.. أدعو الله وأرجوه أن ينجو رجالُ الخدمة الذين وفقهم الله لإنجاز هذه الخدمات العظيمة من هذا الفيروس رغم كل الشرور والمعوقات التي وضعها الأشرار أمامهم.
إن أسلم طريقٍ للحيلولة دون الانجراف في دوامة الحياة الدنيا هو ارتباط القلب بالغايات السامية، والحرص على تحقيق المثل العالية، فلا يصحّ لمن جعلوا غايتهم إعلاء راية الاسم المحمدي الجليل في كلّ مكان أن يتغيّوا غايةً أدنى من ذلك، لأن مثل هذه الغاية السامية هي أهم من جميع المقامات والمناصب الدنيوية، بل ومن تأسيس مئات الإمبراطوريات في العالم.
إن من يبتغون رضا الذات الإلهية ويستهدفون الآخرة لا يولون أهمية لوجه الدنيا المتعلق بالجسمانية والحيوانية، والذين يرنون بأعينهم إلى رؤية الحق جل وعلا يصونون أعينهم عن رؤية أي شيء آخر، والذين يُقبلون عليه سبحانه ويتوجهون إليه يكفّون عن البحث عن أيِّ قبلةٍ أخرى يتوجّهون إليها، ولو تمثّلت لهم الدنيا بجمالها ورونقها وروعتها لَرَأوها شيئًا ضبابيًّا قذرًا معتِمًا، وربما لا يرونها شيئًا أبدًا.
يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض حديثه عن قيمة الدنيا وقدرها: “لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ”[3]، هذا هو قدر الدنيا وقيمتها! فلِمَ إذن يطمح الإنسان الذي أُرسِل إلى الدنيا بجاهزيةٍ عالية إلى مثل هذا الشيء الدنيء في حين أن الأَوْلى به أن يطمحَ إلى الغاية، ويتمسّك بالهدف الذي يوصِّله إلى قممٍ شاهقة، ويجعله يظفر بنعمٍ تتجاوز جميع الخيالات.. أما الذين أسلموا قلوبهم للدنيا، وجعلوها شغلَهم الشاغل في حِلّهم وترحالهم؛ فقد أنفقوا كلَّ زادهم الأخروي لحساب الدنيا الزائل، ورحلوا إلى دار الخلود دون زادٍ ومتاع.
وعلى ذلك فحتى لا ننخدع بمفاتن الدنيا وإغراءاتها علينا أن نقوي الصلة مع الله تعالى، وأن نضع توجهَ الله، وعنايتَه، ومعيته، وحفظَه، وحمايتَه، ونصرَه، ومعونتَه؛ في البؤرة المركزية لأدعيتنا، فلا نكفّ عن الدعاء قائلين: “اللهم املأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك!”، ولا نهمل التضرّع إلى الله، وندعوه أن يزيد إيماننا ويقيننا به وتوكلنا عليه وتسليمنا له وثقتنا به سبحانه وتعالى، ثم نعلم في النهاية أن كلَّ هذا لا يفي بحقّه سبحانه وتعالى.
ونختم كلامنا بأننا لا نستطيع أن نعبد الله حقّ العبادة، ولا نعرفه حق المعرفة، ولا نحمده ونثني عليه حق الحمد والثناء؛ فلعل اعترافنا بعظمته وصِغرِنا وضحالةِ عبوديتنا يمسّ مرحمته ويلامس سعة رحيميّته، فيرحم عجزَنا عن الوفاء بحقّ العبودية، ويجبُر نقصَنا، ويسدّ فراغاتنا.
فإذا أردنا أن نظفر بتوجّه الله ورحمته ورضاه ورضوانه في الآخرة فعلينا أن نطمح إلى هذه الغايات وننشدها دائمًا في الدنيا، وكما أكَّدْنا مرارًا فإن الإقبال يتبعه إقبالٌ أعظم منه، وإذا أدركنا هذا جيدًا، وعلِمْنا أن الدنيا الفانية ما هي إلا طريقٌ وممرٌّ للوصول إلى الله ولقائه؛ فلا يمكن لها أن تفرض نفسها علينا، ولا تفتننا بنعيمها ولا تخطف أبصارنا.. إننا إذا ما نظرنا إليها بهذا المنظار؛ فإن هذه الدنيا التي لا قيمة لها كالفحم والغبار؛ تتحول فجأة إلى ياقوت وألماس وزبرجد.
[1] بديع الزمان سعيد النورسي: الملاحق، ص 132.
[2] سنن ابن ماجه، الصيام، 21.
[3] سنن الترمذي، الزهد، 13؛ سنن ابن ماجه ، الزهد، 3.