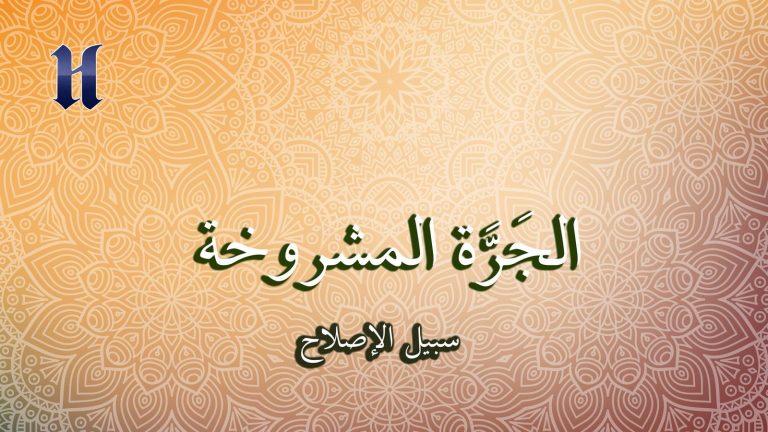سؤال: ما الرسائل التي تحملها وتنقلها إلى الناس الآيةُ الكريمة: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَاْلأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (سُورَةُ الزُّمَرِ: 39/67)؟
الجواب: إن عبارة “وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ” الواردة في صدر الآية تعني: أنهم ما عرفوا الله تعالى حقَّ معرفتِهِ مستجمعينَ صفات جلالِهِ وجمالِهِ، وما عظَّموه حقَّ تعظيمه؛ إذ تجاهلوا قدرتَهُ المطلقة الغالبة على كل شيء، ورحمتَه وشفقتَه الأبدية، ونِعَمَهُ وألطافَهُ التي أَنْزَلَها على عبادِهِ، فلم يُعَظِّموه بما يليقُ به وبشأنِهِ العظيم سبحانه؛ ولذلك فقد انزلَقُوا في مستنقعِ إنكارِ الجميلِ وعدم تقديرِ الجليلِ.
ومن عبارة “حَقَّ قَدْرِهِ” نفهم أنه وإن كان بين هؤلاء الناس من قدَّره وعظَّمه جلَّ جلاله بقدرٍ معين إلا أنهم لم يقدروا ذا الجلال والكمال بالشكل الذي يستحقُّه ويليقُ بذاتِهِ العليّة؛ فثمّة فرقٌ بين “مجرد التقدير” و”التقدير بحقٍّ”؛ فالله تعالى هو من خلَقَنَا، وجعلنا في أحسن تقويم، ودعانا إلى الصراط المستقيم بواسطة الرسل والأنبياء وهدانا إليه، وحَفّزَ هِـمَمَنا بما وعدنا به من خيرٍ جزيلٍ، ووجَّه أبصارنا إلى دار القرار، ولم يكِلْنَا إلى أنفسنا طرفةَ عين، ومعرفةُ كل هذه الأمور واحترامُه تعالى وشكره بناءً على هذا العلم يمثل تقديرًا من العبد لربه سبحانه وتعالى، وأما خلاف ذلك فهو عمى وكفر للنعمة وعدم تقدير.
وتضرب الذاتُ الإلهيّة مَثلًا على عظمتها وجلالها بقوله تعالى: “وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“؛ أي إنَّ الدنيا تبدو نقطةً صغيرة وشيئًا تافهًا بالنسبة لقدرة الحقِّ تعالى أيًّا كان حجمُ هذه الدنيا وجسامتُها في نظركم، وتعبير الآية عن قدرتِهِ سبحانه على الأرض إنّما يُقدِّم لمن يعيشون فيها رسالةً مفادُها أنْ: “اخضعوا أمام قدرتِهِ القاهرة وإرادتِهِ الباهرةِ، وتحركوا في دائرة الأمر والطاعة”.
وتخبرنا الآيةُ بعبارةِ “وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ” الواردةِ قبل خِتامها أنه سبحانه وتعالى سيطوي السماوات كطَيِّ السِّجلِّ للكتب؛ فيجعلها مطويّة كالورقِ الملفوف.
أما عبارة “سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ” التي تُشَكِّلُ فذلكة الآية فتعني أنَّ الله مُنَزَّهٌ ومُبَرَّأٌ عما يشركُونه به هؤلاء.
بُعْدَا الخشية: المعرفي والوجداني
ثمة درجاتٌ مختلفةٌ لتقديرِ الله تعالى وإجلالِهِ تتفاوتُ بحسب مدى التعمُّقِ أو السطحيّة في الشعور بقدرة الله وعظمته في الكون، ودرجةِ الإحساس بما يغمرنا به من نِعَمٍ وألطاف.
وقد يتبادرُ إلى الذِّهْنِ هنا هذا السؤال: “هل هذا التقدير مجرّد معرفة، أم أنه يشمل كل أعضاء الإنسان بما فيه من لطائف؟” كما أن المحبة تتشكَّلُ وتنمو في أحضانِ المعرفة؛ فإن الحب مرتبطٌ بالعِلم؛ والأمر هكذا تمامًا إِنْ تكوَّنَ في القلبِ شعورٌ بالخشية أي شعورٌ بالخوف أساسُهُ ومحورُهُ احترامُ الله وتعظيمُه تعالى؛ فمثلُ هذا الشعور يقف وراءه العِلم بالدرجة الأولى، ومن ثم فربما يتحوَّل العلم إلى معرفةٍ وثقافةٍ وجدانيّة، ثم إلى طبيعة في الإنسان وعمقًا من أعماق طبيعته نتيجةً لذلك، والطاعات التي سيؤدِّيها المؤمنُ بعد هذه المرتبةِ تُصْبِحُ أحداثًا تتشكَّلُ بِفِعْلِ ما فيه من دوافع داخليّة، أي إنَّ قول الإنسان: “سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، اَللهُ أَكْـبَـرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُـكْرَةً وَأَصِيلًا” على سبيل المثال لن يكون لمجرد أنه أُمر ووُصِّي بقول هذا فحسب، بالعكس سوف تنبعُ من داخله هذه العبارات التقديريّة والتعظيمية مباشرةً حالَمَا يفيضُ قلبُهُ جَيَاشًا فائقًا بتدبُّرِ الأشياء والحوادث، ومطالعة القدرة القاهرةِ والإرادة الباهرة؛ فيسمو سُمُوًّا يفوقُ شعوره بالامتثالِ للأمرِ.
ومن هذه الناحية يتسنَّى القولُ إنَّه يمكن للمؤمن أن يُعَبِّرَ عن مشاعرِ تقديرِهِ للقدرةِ القاهرةِ والإرادةِ الباهرةِ والمشيئةِ السبحانية نظريًّا، غير أن حقيقةَ المسألةِ تكمُنُ في تحويلِهِ هذا التقدير إلى بُعدٍ داخليّ، وجعلِهِ جزءًا من طبيعتِهِ، وإلا فإنّه سَيُعَبِّرُ عن مشاعر التقديرِ والتعظيمِ لِمُجَرَّدِ أنه أُمِرَ بهذا فحسب، أو حينما وحيثما يُذكَّرُ بذلك، وأما القلوبُ المؤمنة التي شَكَّلَتْ مَعْسَلَةَ المعرفة في وجدانها بالتفكُّرِ والتدبُّر هي تلك التي تمتلِئُ وتفيضُ بأحاسيسِ التعظيمِ والتقديرِ في كلِّ مرحلةٍ من مراحل حياتها، بل وفي كل فينةٍ من حياة بعضها، فمثلًا حين يواجه حادثة ما يرى فيها تجلي القدرة والعظمة الإلهية يقول متأثرًا بها: “سُبْحَانَ اللهِ”، وحين يرى أنه قد غُمِرَ بالنعم من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه يُـردِف من فوره قائلًا: “الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا”، ويفيض حمدًا لله تعالى وثناءً عليه، وحين تتراءى أمام ناظريه تلك الإجراءات العظيمة الجسيمة التي تدلُّ على عَظَمَةِ الله تعالى وجلالِهِ يلهجُ بذكر الله وتعظيمه قائلًا: “اَللهُ أَكْـبَـرُ”.
وكما قال “رجائِيزاده محمود أكرم”:
الكون كُلُّه كتابُ الله الأعظمُ
فإذا تصفَّحْتَ أيَّ حرفٍ منه وجدتَ الله الأكرم
أي إنَّ أيَّ حرفٍ يعرضُ للمؤمِنِ يُعَبِّرُ له عن الله تعالى بما يَليقُ بِعَظَمَتِهِ وجلالِهِ، وذلك هو التقديرُ الحقيقيُّ، والمهمُّ هنا هو أن يجعلَ الإنسانُ تقديره لله تعالى مسألةً وجدانيّةً فطريّةً فيه.
تأثيرُ الخشيةِ على الفردِ ومحيطِهِ
ثمة حديثٌ نبويٌّ شريفٌ من شأنِهِ أن يُسَلِّطَ الضوءَ على هذا الموضوع، ألا وهو قول مفخرة الإنسانية صلى الله عليه وسلم حين رأى من يعبثُ بِلِحْيَتِهِ في أثناء صلاته: “لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هذا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ“[1]، فإن كان قلبُ الإنسان عامرًا بشعور الخشية من الله واحترامه حقَّ الاحترام سَرَى هذا في كلّ تصرُّفاته وسلوكيّاته حتى إنه يهيمن على كلَّ إيماءاته وإشاراته.
وهكذا فإننا حين ننظرُ إلى تصرُّفات وحركات وسكنات الأشخاص العظام من أصحاب القلوب العامرة بالخشية والتقدير فإننا نشعرُ ونُحِسُّ بأمارات وانعكاساتِ خشيَتِهم لله تعالى؛ وإذا ما خالَطْنَاهم اصطبَغْنَا بِصِبْغَتِهِم وحظينا بالسكينةِ والطُّمأْنينةِ؛ فقد عِشتُ تلك المشاعر والأحاسيس التي تشرح صدر الإنسان حين كنت أَشرُف بالوجود في حضرة الشيخ “محمد لطفي أفندي”؛ فهولاء الأشخاص العظام حين يذكرون اللهَ جلَّ جلاله والرسولَ صلى الله عليه وسلم أو يتصرَّفون بحساسيّة في شتى المواضيع يـبـثُّـون فيكم من الإيمان والإذعان ما تعجزُ الكتب أن تُعبِّـرَ عنه، وحالُ الشيخ محمد لطفي أفندي كان خيرَ مثالٍ لـهذا؛ فذات يوم حضر إليه أحدهم وقال: “سيدي الشيخ! حَجَجْتُ، فوجدت أن الكلاب التي في المدينة المنورة قد أصابها -من الإهمال أو من غيره- الجَرَبُ!!” فلما سمع الشيخُ هذا القولَ انتفضَ قائلًا: “اُسكُتْ! فالمدينةُ روحي فداها، بل وحتى فِدى كلابِها الجربة!”، ولا بدَّ أنَّ ما دفعَ فضيلةَ الشيخ لقولِ تلك الكلمات هو تَرَبُّعُ حبِّهِ العميقِ واحترامُه الجمّ لمفخرةِ الإنسانية صلى الله عليه وسلم على عرشِ قلبه، فعبَّرَ الشيخ من فَورِهِ عن هذه الحساسيّة، وهكذا فإن المسألةَ الحقيقيّة الجوهريّة هي إسلامُ المرء نفسَهَ لشلَّالٍ من الخشوع والخشية بحساسيّة عميقةٍ تجاهَ القِيَمِ المقدّسة، وتوجُّهَه إلى حيث يذهبُ به ذلك الشلال.
قيمةٌ مهمّة افتقدناها
مما يؤسف له أنَّ غرسَ هذه الأمور في الوجدان هو من أهمّ القِيَمِ التي افتقدناها؛ فقد افتَقَدْنَا نحن -ضحايا الإسلام الشكلي- قلوبَنَا، ونَسِينَا ديناميكيَّاتنا الداخلية، ومع أن بعضًا من القِيَمِ المنسوبة إلى الدين قد عُلّمَتْنا -نسأل الله أن يرضى عمَّن علَّمُوها- إلا أنّنا اكتفينا بالمعلومات النظريّة والتقليديّة والنقلِ فحسب دون أن نتمكّنَ من تعلُّمِ القِيَمِ الخاصّة بحياة القلب والروح، ومن ثمَّ لم يتسنَّ لنا أن نعيشها ونحياها، وكما ورد في قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (سُورَةُ الشُّعَرَاءِ: 88/26-89)، وقوله: ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ (سُورَةُ البَيِّنَةِ: 8/98)؛ فإن امتلاك الإنسان “قلبًا سليمًا” ينقذُهُ في الدار الآخرة إنما يتحقق باحترامه اللهَ ربَّه وخشيتِهِ منه سبحانه وتعالى.
وإنَّ عدم تأثُّرِ قلوبِنا بتلك الآية التي تُزَلْزِلُ المنابرَ والمحاريبَ إنّما هو تعبيرٌ وأمارةٌ أخرى على حالنا الذي يدعو إلى الحسرةِ والندامة؛ فذات يوم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف الآيةَ الواردة في هذا السؤال -الذي يشكل أساسَ موضوعِنا-؛ فتحرَّكَ المنبرُ تحته صلى الله عليه وسلم حتى كاد يُسْقِطُهُ عليه الصلاة والسلام من فوقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، ويحركها، يقبل بها ويدبر ثم قال: “يَأْخُذُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَمَاوَاتِهِ وَأَرَضِيهِ بِيَدَيْهِ، فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ -وَيَقْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا- أَنَا الْمَلِكُ“، يقول سيدنا عبد الله بن عمر راوي الحديث: نظرتُ إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقطٌ هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟![2].
ولو أننا لم نفقدْ قلوبَنا وأحاسيسَنا لأَرْجَفَتْها هذه الآيةُ الجليلةُ التي هزَّتْ المنْبَرَ النبويَّ، ودفعَتْنَا إلى الخشيةِ.
فندعو الله تعالى أن يوفِّقَنا إلى النجاةِ من الشكليّة والسطحيّة، ويمكِّننا من النفوذ إلى الجوهر، وينقلنا من القالب إلى المعنى، وأن يملأ قلوبنا بشعورِ الخشيةِ حتى تُسيطِرَ وتسودَ في كلِّ تصرُّفاتنا وسلوكيّاتنا مدى الحياة! اللَّهم آمين.
[1] عبد الرازق: المصنف، 266/2؛ ابن أبي شيبة: المصنّف 86/2؛ البيهقي: السنن الكبرى، 404/2.
[2] صحيح مسلم، صفات المنافقين، 25؛ مسند الإمام أحمد: 304/9.