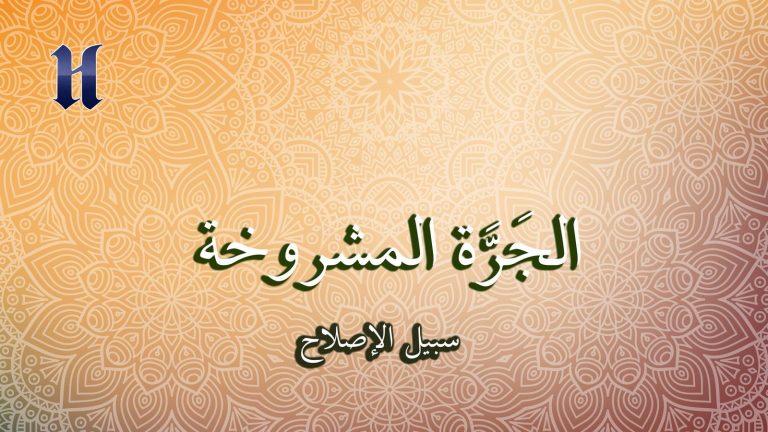سؤال: ما هي الرسائلُ الكامنة في الآيات التي تتحدُّث عن طغيانِ الشيطانِ وإضلالِه كقولِه تعالى: ﴿وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 118/4-119)؟
الجواب: لقد بَيّنَ الله عصيانَ الشيطان في مواضع متعددة من القرآن الكريم؛ ففي سورة الحجر مثلًا نجد الشيطان بسبب حسدِهِ الإنسان وبغضه إيّاه تحدث بوقاحة وصفاقة فـ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (سُورَةُ الْحِجْرِ: 39/15)، وفي سورة “ص” ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ (سُورَةُ ص: 82/38)، وكذلك أيضًا فقد فصَّلَ القرآن الكريم موضوعَ هَذَيَانِ الشيطانِ الممتلِئِ حقدًا وكرهًا في قولِهِ تعالى: ﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (سُورَةُ الأَعْرَافِ: 16/7-17).
ولا تختلف تلك العبارات عن بعضها من حيث إنَّها تعبير عن ضلالٍ وانحرافٍ واحدٍ، فالشيطان أسيرُ الغيرة والحسدِ، وقد أسلمَ نفسه في الوقت نفسه للحِقْدِ والكرهِ، وأعمَتْهُ تمامًا تلك المشاعرُ القاتلة؛ فتدفَّقَتْ من فمِهِ هذه الصنوفُ من الأباطيل وهو في حالةٍ من الهذيان، ومن ثمَّ فإنَّه تكلم وتحدث وتصرف نتيجة هذه المشاعر السلبية المُسيطرة عليه رغم أنه يعرف الحقيقةَ جيدًا.
طاغوتٌ يسوقُ مجموعات من الطواغيت
والواقع أنَّ تلك العبارات التي تلفَّظ بها الشيطان بوقاحة وصفاقة تجاه الله تعالى تُبيِّن أنَّه كان في السابقِ ينطوي على مرضٍ نفسيٍّ خطير، من الممكنِ أن يكون من قَبيلِ التشوُّفِ إلى منصبٍ أو مقامٍ أو إلى تقديرٍ وتبجيلٍ، لأنهُ رُوِيَ عن بعض المحققين قولهم: إنَّه لم يبق مكان على وجه البسيطة إلا وسجد فيه الشيطان لله تعالى، وهو يعرف الله كما يُفهم من قَسَمه وحَلِفِه به سبحانه وتعالى، غير أنَّ معرفته الله لم تفده شيئًا؛ لأنها معرفة بلا عملٍ، ونتيجة لذلك فقد تردَّى في مستنقع الغيرة، ولم يتقبل آدمَ عليه السلام، وانهزم أمام مشاعر الحسد.
والشيطان يهذي ويهرِف كلما رأى نجاحَ الإنسان وأداءه ونشاطه العاليَ في سبيل الله تعالى، ويشتد عداؤه للإنسان حقدًا عليه فيصير واحدًا من ألدِّ أعداء الإنسانية، وهو بهذا يقف وراء عصيان وضلال كل المجموعات العصيّة الضالّة، لأن الإنسان المخلوق في “أحسن تقويم” غيرُ منفتحٍ باعتبار فطرته الأصلية على الدهماوية والجدلية وتشويه الآخرين والحسد وما إلى ذلك، وإنَّ مَنْ يقعون في مثل ذلك إنما يقعون فيه بِلَمْزِ الشيطان وغمزه حتى وإن كانوا يظنّون أنهم يستخدمون خلاياهم العصبية وعقولهم، أو يعتقدون أنَّ تلك الأمور السلبية التي يتفوّهون بها من نتاجِ أدمغتهم أنفسهم، أو يتوهَّـمون أنهم هم منْ جعل بعضَ السلبيات أمرًا واقعًا.
وتذكر الآيات الكريمة أنَّ الشيطان سيلجأ إلى عِدَّةِ طرق ومسالك في محاولةٍ منه لإضلالِ الإنسان عن الصراطِ المستقيم حَسَدًا منه وحقدًا؛ فتأمر الآيةُ التالية المؤمنين بالتَّمَسُّك بالطريق المستقيم الذي بَيَّنَه الله تعالى وبعدمِ الابتعاد عنه قائلة: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (سُورَةُ الأَنْعَامِ: 153/6)، لأنَّ من ينحرف عن هذا الطريق المستقيم يضلّ في طرق شتّى، ويقع أسيرًا لهواه وشهوته؛ فيتخبط بين اتباع هذه الأيديولوجية وتلك، ويظنُّ أن تلك الأضواء الكاذبة تمنح الإنسانية السعادة والرفاه، ونتيجة لذلك فإنه يُفني عمره لهثًا وراء أيديولوجيات باطلة، في حين أن السبيل الأنسب لطبيعة الإنسان واحتياجاته والذي سيضمن السلم والطمأنينة للمجتمع إنما هو السبيل الذي حدده اللهُ خالقُ الإنسان وصاحبُ الرحمة والعلمِ المطلق، أما الشيطانُ المفسدُ البارع في الإفساد الذي يعلم هذا الأمر جيدًا فقد حاول وما زال يحاول إضلال الناس وإبعادهم عن هذا الطريق المستقيم مستخدمًا آلاتٍ ومزامير مختلفة بحسب ظروف الزمان واختلافِ الشخصيات.
حقدٌ دفينٌ
إنَّ الشيطان حينما أرادَ أن يُعبِّرَ عمَّا ينوي فعلَه أنشأ عبارةً محلَّاةً بلامِ القَسَمِ ونونِ التوكيدِ فقال: ﴿لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾، ولامُ القَسَم الواردة في أوَّل الفعل ونونُ التوكيد اللاحقة بآخره أيضًا تُبَيِّنان مدى إصرار الشيطان على إغواء الإنسان، أي وكأنَّه قال سأستعبد جزءًا منهم، وأُخضعهم لوصايتي، وأُؤثر عليهم دائمًا.. ويمكننا اليوم مشاهدة أمثلة وأنواع عديدة وكثيرة للغاية من هذا القَبيلِ.
وإثر ذلك أردف الشيطان مؤكِّدًا ما ينوي فعله ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ﴾؛ أي إنّني لن أبرحَ حتى أُفسِد عليهم أفكارهم ومشاعرهم، وسأفعل كلَّ ما بوسعي كي أُضِلّهم عن السبيل؛ فأدفع بعضهم إلى البوهيمية[1]، وأجعل بعضهم عبيدًا للسمعة والشهرة، وأُجنِّنُ البعضَ بجعلِهم يستميتون طمعًا في الحظوةِ والمستقبَلِ، وأُحرقُ البعضَ الآخرَ بمشاعر الجشع، وأَزُجُّ بفِئَةٍ في مستنقع الحسد، بينما أزجُّ بالأخرى في مستنقعِ الاستبدادِ والغطرسة وعدمِ الاعترافِ بحقِّ الغير في الحياة، فأجعلهم يُهرولون من ارتكاب ظلمٍ إلى آخر، وكل واحدة من هذه الأمور انحرافٌ قائم بذاته يسوق الإنسان إلى الضلال، ولذا فإننا ندعو الله جلَّ وعلا أربعين مرة على الأقل يوميًّا في صلواتنا الخمس كي لا نضل ولا نزيغ عن الطريق المستقيم فنقول: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ (سورةُ الفَاتِحَةِ: 6/1-7).
الشيطانُ والدين المفرَّغُ من محتواه
ومن التهديدات التي يسوقها الشيطان حين يستشيط حقدًا وكرهًا قَسَمُهُ القائل: ﴿وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ﴾، ويطلق لفظ الأمنية على الأوهام والهواجس التي لا تستند إلى حقيقةٍ والتي يتعذر تحقيقها، وقد كان تفاؤُلُ أهل الجاهلية أو تشاؤُمهم من تلقاءِ أنفسهم استشفافًا من مجموعة من الأحداث، وتيمُّنُهم ببعض الأشياء وتبرُّكهم بها، وتطيُّرُهم بالبعض الآخر نوعًا من تلك الهواجس والأوهام، وكذلك فإنَّ الأوثان التي عبدوها كانت من نتاجِ تلك الأمانيّ؛ فقد كانوا يضعونَها حتى داخل الكعبة، واشتهرَت في أماكن شتى من الجزيرة العربية أصنامٌ شبيهة باللات ومناة والعزى وإساف ونائلة.. فكانوا يذبحون لها القرابين ويعبدونها، وفي وقتِنا الراهن هناك مَن يُسوِّقون النهبَ والسرقة والكذب والافتراء على أنها أمورٌ مشروعةٌ، ويظنون أنهم سيُحقِّقون مكسبًا ويَصِلُون إلى مكانةٍ ما بالمفاهيم الدينية التي أفرغوها من محتواها، وما فِعلُهم هذا إلا نتاجُ نوع آخر من الهواجس والأوهام أيضًا.
وفي بقية الآية الكريمة يقول الشيطان: ﴿وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْأَنْعَامِ﴾؛ فكان من عادات أهل الجاهلية أنهم يشقُّون آذان بعض الحيوانات فتكون علامة عليها، ويُحرّمون على أنفسهم أكل لحومها، ويفعلون ذلك نسكًا في عبادة الأوثان، فيحرِّمون ما أحلّه الله سبحانه وتعالى.
أكبرُ تغييرٍ: الانحراف عن غاية الخلق
ويواصل الشيطان وقاحته وصفاقته قائلًا: ﴿وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾، فاللهُ تعالى خلق كلَّ الكائنات على فطرةٍ، يُعَدُّ إحداث أيّ تغيير فيها وقوعًا في حيلةٍ من حِيَلِ الشيطان، فالإنسانُ المخلوق في أحسن تقويم إذا تحرك في إطار النُّظُمِ والأسس والمنهجِ الذي وضعهُ الله تعالى يكون قد تحرَّكَ وفقًا للفطرة التي فُطِرَ عليها، وإلا فإنه يُسلِمُ نفسه للتَّشَتُّتِ والفُرقة، وينحرفُ عن جادَّةِ الفِطرة السليمة.
وإلى جانب تلك الأمور فإنه عندما يُنظر إلى الآية الكريمة من زاوية التفسيرات الحديثة يمكن استلهامُ إشارةٍ إلى عمليات التجميل التي شاعت اليوم؛ إذ إنَّ عدم إعجاب الناس بشكل بعضِ الأعضاء من الجسدِ، وقيامَهم بتغييرها وفق أهوائهم شكلٌ آخر من أشكال التدخُّل في الفطرة، وهي أيضًا وقائع تجري بهمز الشيطان وإغوائِهِ، أمَّا علاج التشوُّهات التي تحدث في الجسد بسبب تلقِّي العلاجات الخاطئة أثناء عملية الولادة أو نتيجة حادثة ما وتحسينُها فإنه لا يندرجُ ضمن التدخُّلِ في الفطرة ومحاولة تغييرِها، بل على النقيضِ، إذ إنه يُقبَلُ ويُنظَرُ إليه على أنه إعادة الأمر إلى أصلِ فطرة الله تعالى.
والواقع أن مسألةَ “تغيير خلق الله” تعبيرٌ عام، ومجالَ انعكاساتها واسعٌ، وقد بيّن الله تعالى بقوله ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (سُورَةُ الذَّارِيَاتِ: 56/51). لماذا خُلِق نوعُ بني الإنسان؟ فالآيةُ تجيب على هذا السؤال بأن الهدف الأساسي لوجود الإنسان هو عبادة الله تعالى؛ فقد خلق الله الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى، لا لشيء آخر، وهذا يعني أنَّ من لا يعبدون الله يسعون لتغيير فطرته وخلقه، ومثل هذا تمامًا كلٌّ من العقل والمنطق والمحاكمة العقلية فإن لها مجموعة من الغايات والمقاصد التي خلقت من أجلها مثل التفكّر والتدبّر والتأمّل في الأنفس والآفاق، وتحليل الأوامر التكوينية، ومن يدقق هذه الأوامر التكوينية ويستخرج منها مجموعة من المعاني، ويؤلف بين تلك المعاني التي استخرجها والأوامر التشريعية، ويتوجه بعد أن يُحسِنَ قراءة الأسرار الخاصة بالربوبية نحو توحيد الألوهية والعبودية؛ يكون حينئذٍ قد استخدم عقله ومنطقَهُ في اتجاه الفطرة، وكما أن المخترعين الإسلاميين كانت لهم اختراعات مهمة للغاية نفعت الإنسانية جمعاء في تلك الفترة التي استمرت فيها النهضة الإسلامية حتى القرن الخامس الهجري؛ فهناك كثير من الباحثين الغربيين أيضًا يقومون في عصرنا بالشيء نفسه عبر حُسنِ استخدامهم المنطق والمحاكمة العقلية التي وهبهم الله إياها.
والمقاربةُ عينُها واردةٌ بالنسبة لأعضاء الإنسان أيضًا؛ فالعين مثلًا لها غاية من خلقها، وهي النظر إلى الأشياء التي يجب النظر إليها، ومحاولة رؤيتها بشكل صحيح وتدقيقها، ومحاولة استخراج بعض المعاني منها، وكما قال الأديب التركيّ “رجائي زاده محمود أكرم” فإنَّ الكون يبدو من أوّله إلى آخره وكأنه كتابٌ رائعٌ إذا ما طالَعنا أيًّا من حروفه وجدنا الله تعالى، وإنَّ البيت الشعري الحكيم التالي الذي نُظم قبل عصورٍ:
تَأَمَّلْ سُطُورَ الْكَائِنَاتِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَإ الْأَعْلٰى إِلَيكَ رَسَائِلُ
ليستحق التأمل في معناه، وعليه فإنَّ المهم هو التمكُّن من رؤية قدرة الله تعالى ومشيئته وعلمه وإرادته حتى في أوراقِ الأشجار، وفي الشتلاتِ والفسائلِ المتمايلة، ولا سيما في الإنسان فإنه بِيَدَيه ورجليه، ولسانه وشفتيه، وعينيه وأذنيه مَعْلَمٌ يُـمَثِّلُ كتابًا بحجم مجلدات لا بدَّ من مطالعتها، ومحاولةُ الإنسان قراءةَ هذا الكتاب قراءةً صحيحة تعني استخدامه عينيه ومنطقه ومحاكمته العقلية في اتجاه الفطرة السليمة.
وبنفس الشكل فإنَّ استماع الإنسان الغِيبة والافتراءات والأكاذيب والأشياء الماجنة بأذنيه لَيُبَيّن ويكشف أنَّه لم يستعملْهما لما خُلِقتا له، وهذا يُعتبر نوعًا من الإسراف، ولذلك فإن الله الذي وهب الإنسان تلك النعم سيحاسبه عليها يوم القيامة، وقد منح الله تعالى الإنسانَ نعمة اللسان التي بها يرتفعُ ويُفضَّلُ على غيرهِ من سائرِ الأحياء، فبفضلها يستطيع الإنسان التعبير عن أدقِّ التفاصيل، وكذلك فإنَّ هذه النعمة الكبرى ذات غاية محدّدة؛ تتمثَّل في عدم الانزلاق في اللغوِ والكذبِ، وأن ينطقَ بالحقِّ والحقيقة، ويُرشِدَ إلى محاسن الأمور.
ويَتَبين من العبارات الوَقِحَةِ التي تفوه بها الشيطان أنَّه يسعى ليمنع الإنسان من أن يستخدم في سبيل الخير والجمال تلك القابليات الممنوحة له، فنجده مثلًا يُلَقِّنُ الإنسان كيف يستخدم عقله في خداع الآخرين، ويُشرعِنُ له كلَّ الطرق كي يتمكن من الوصول إلى هدفه بفهم أنانيٍّ وصوليٍّ (مقياولي)، والأكثر من ذلك أن الشيطان سيسعى كي يُجمّل حتى لمن يرتادون المساجد كلَّ فهمٍ إباحي، وسيدفعُهم للاستفادة من نعم الدنيا دون تحرٍّ للحلالِ والحرام، ويجتهد كي يُبعد عن طريق الله تعالى حتى أولئك المداومين على الصلاة، ومن ثم فإن الإنسان إذا لم يستخدم الملكات والقابليّات الموهوبة له في الطريق الصحيح فقد اتبع همزات الشيطان، وتدخل في الفطرة، فيصبح دون أن يدري أبدًا خاضعًا لأمر الشيطان؛ ولهذا فقد حذر القرآن الكريم من الشيطان ومن مكائده بأسلوب يُرجِفُ القلوبَ ويُنبِّهها فقال: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ (سُورَةُ النِّسَاءِ: 119/4).
وعليه فلا بد أن يضع الإنسان في اعتباره أنَّ الشيطان ربما يقف وراء كل حركة تخالف ما أمر الله تعالى به في القرآن، وينبغي له أن يُديم الاستعاذة بالله من الشيطان، وأن يُخْلِصَ التوجُّهَ إلى الحقِّ تعالى ويطلب المدد منه، وأن يتمسك بالتصرُّفات والسلوكيات التي تطردُ الشيطانَ وتُبعده عنه، فعليه مثلًا أن يَلْزَمَ الصلاةَ وتلاوةَ القرآن؛ فقد ورد في الحديث النبوي الشريف أنَّه “إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ”[2]، ولأجلِ ذلك فإنَّه ينبغي لمن ينشد الحق ويرغبُ في أن يَسْلَمَ من كلِّ حيل الشيطان ومكره أنْ يعيش حياته عبدًا لله فحسب، وأَنْ يَجِدَّ في سبيل إعلاء كلمة الله، ويعتبرَ نفسه صِفْرًا ويتوجَّه إلى الله لا إلى أحدٍ سواه، فكل هذه الأمور بمثابة أسوار تُقام منعًا من وصول الشيطان إلى الإنسان، أمَّا من يسيرون في سبيل الله ويُقحمون في أثناء ذلك أنفسَهم وملاحظاتهم النفسيةَ ومصالحهم الشخصيةَ فهم أموات بالنظر إلى حيواتهم القلبية، كما أنهم بصنيعهم ذلك يهدمون حصونهم القلبية ويُسلمون قلوبهم للشيطان، نسأل الله السلامة.
[1] البوهيمية: طريقة في الحياة تقوم على التسكُّع واللامبالاة بالوضع الاجتماعيّ أو المعيشيّ وعدم الاهتمام بالمصير والمستقبل.
[2] صحيح مسلم، الإيمان، 133؛ سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، 70.